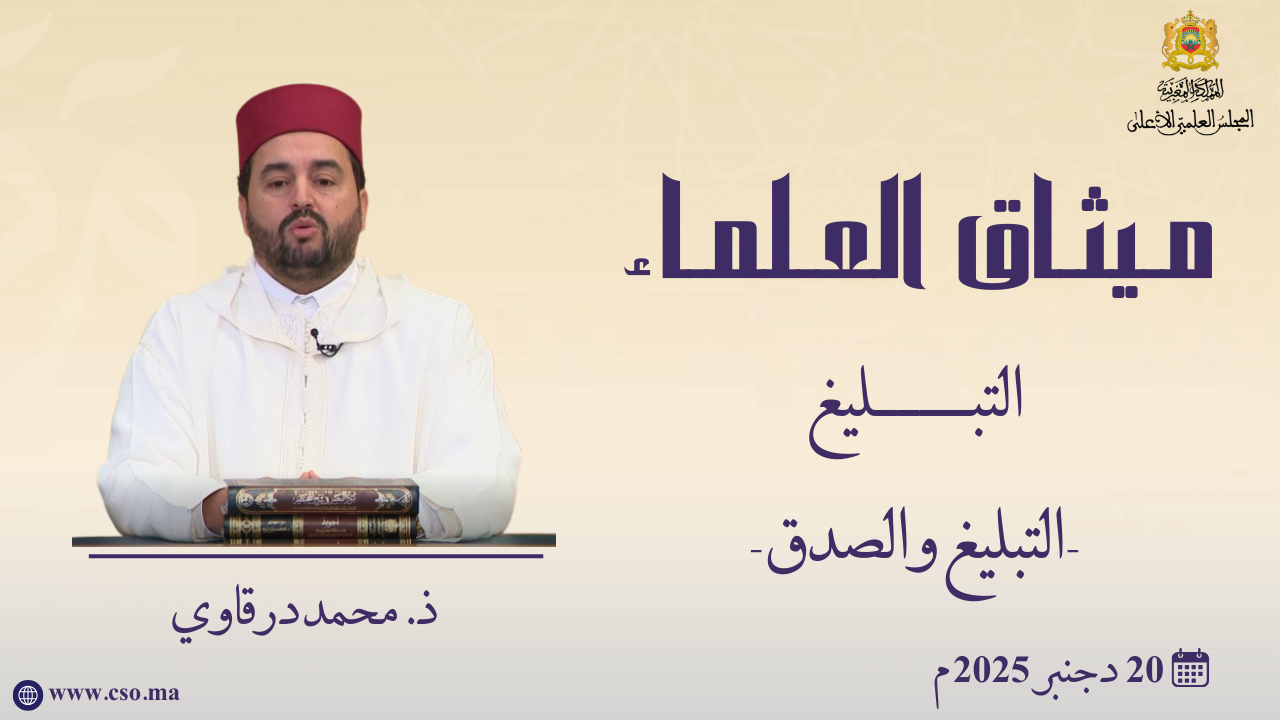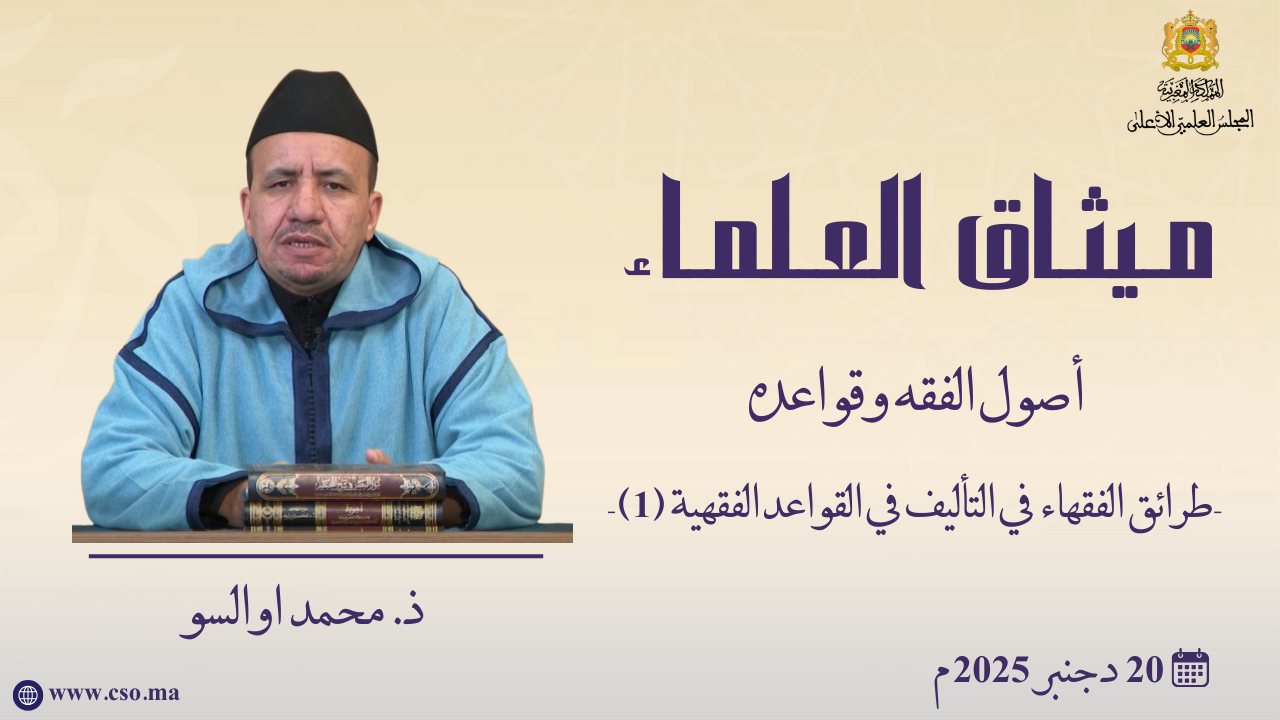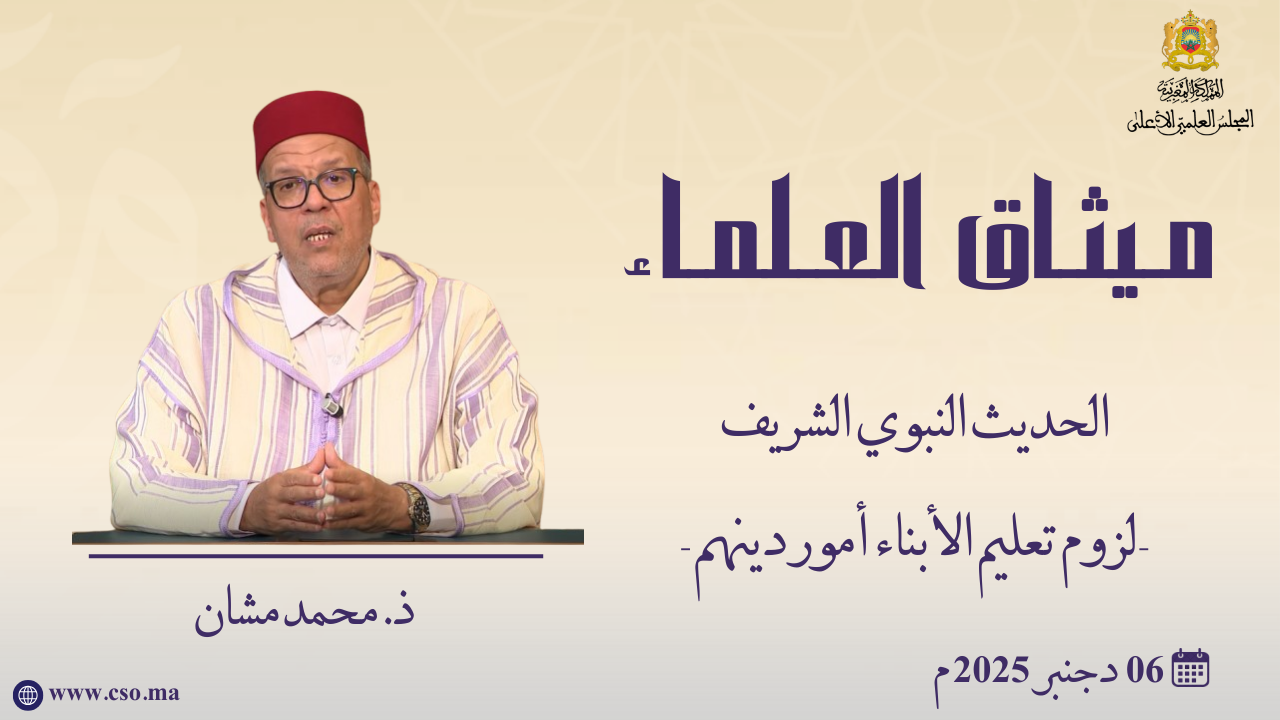النسخة المكتوبة
قال الحق سبحانه: ﴿أَيَحْسِبُ اُ۬لِانسَٰنُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدىًۖ﴾ [القيامة: 35]، لقد خلقنا الله سبحانه ولم يتركنا هملا دون أن يأمرنا بما ينفعنا وأن ينهانا عما يضرنا، دون أن يجازي المحسن عن إحسانه والمسيء عن إساءته، ومثلُه قول الحق سبحانه: ﴿أَيَحْسِبُ اُ۬لِانسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ﴾ [القيامة: 3].
لقد خلقنا الحق سبحانه ولم يهملنا وإنما تعاهد خلقه بما فيه صلاحهم في العاجلة والآجلة، وأوصانا بالعبادة والإخلاص فيها وإقامتها حق قيام وفق ما أمر الله به: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ اُ۬لدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَيُوتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَۖ وَذَٰلِكَ دِينُ اُ۬لْقَيِّمَةِۖ﴾ [البينة: 5].
وتعرض نصوص القرآن والحديث على الناس معان يظهر منها أن الله غني عنا وعن عبادتنا فيقول الحق سبحانه: ﴿وَلِلهِ مَا فِے اِ۬لسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِے اِ۬لَارْضِۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُۥٓ أَنِ اِ۪تَّقُواْ اُ۬للَّهَۖ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِے اِ۬لسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِے اِ۬لَارْضِۖ وَكَانَ اَ۬للَّهُ غَنِيّاً حَمِيداٗۖ﴾ [النساء: 130].
قال الطاهر بن عاشور: “وكان الله غنيا عن طاعتكم محمودا لذاته سواء حمده الحامدون وأطاعوه أم كفرو وعصوه”[1].
وقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: “يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه“[2].
فالعباد محتاجون إلى ربهم في كل الحركات والسكنات، وهو غني عنهم منفرد بالغنى في كل شيء، ووصفهم سبحانه في الآية بالفقر ليظهر لهم شدة حاجتهم إليه وقوة غناه عنهم وذكرهم بوصفه الحميد ليبين لهم أنهم وإن كانوا فقراء وهو غني عنهم، فهو حميد إليهم بالنعم والعطايا.
فالعبادات كلها هي حاجة من العبد للإقبال على ربه حاجة الشوق واللهفة، وهي أعظم منن الله على الناس وأجل منحة له عليهم، والذي ينتفع بهذه العبادات هو الإنسان وحده؛ ينتفع بكل عمل يعمله مما يحب الله ويرضى، سواء قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا.
قال الحافظ بن رجب رحمه الله: “الله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكّله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله، واتبع هواه وكان أمره فرطا”[3].
فإذا علم المؤمن أن هذه العبادات لا تنفعه إلا هو، وعلم أن بها نجاته وبها يتحقق قربه من خالقه؛ “…وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ”[4]، اجتهد أن تكون وفق مراد الشرع ولم يستهن بها، بل أدركتها رعايته وخصها بعنايته.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: “فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته فإن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فأمره مخطر ولكن الرجاء غير منقطع والعفو من كرم الله منتظر، فعسى الله تعالى أن يغفر له بجوده وكرمه”[5].
إن المؤمن ينظر إلى العبادة أنها برنامج حياته بما يسعده في العاجلة والآجلة، وينظر إلى كل فعل يقصد به التقرب إلى مولاه أنه عبادة، قال تعالى: ﴿قُلِ اِنَّ صَلَاتِے وَنُسُكِے وَمَحْي۪آےْ وَمَمَاتِيَ لِلهِ رَبِّ اِ۬لْعَٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُۖ وَأَنَآ أَوَّلُ اُ۬لْمُسْلِمِينَۖ﴾ [الأعراف: 164-165]، وروح ما تضمنته الآية الإخلاص لرب العالمين، وهو ما تفرع عن التوحيد، واللام في “لله” يجوز أن تكون بمعنى تيسير الله، فتكون بيانا لقوله تعالى: ﴿قُل اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيَّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 162]، ويجوز أن تكون اللام للتعليل أي جعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانوا يسجدون لغير الله.
والنسك حقيقة العبادة، ويسمى العابد الناسك، والمحيا والممات يستعملان مصدران ميميين ويُستعملان اسمي زمان من “حيي” و”مات”، والمعنيان محتملان؛ فإذا كان المراد من المحيا والممات المعنى المصدري، فقد قصد بها الأعمال التي من شأنها أن يلتبس بها المرء مع حياته ومع وقت مماته، وإذا كان المراد منها المعنى الزمني كان المعنى ما يعتريه في الحياة وبعد الممات، ثم أن يستشعر الإنسان شرف العبادة ومقامها وأنها محطة لصلاح القلب وزيادة الإيمان والأنوار والبركات، قال الراغب الأصفهاني: “وشرف الإنسان بأن يوجد كاملاً في المعنى الذي وُجد لأجله، ودناءته بفقدان ذلك الفعل منه، فمن لا يصلح لخلافة الله تعالى ولا لعبادته ولا لعمارة أرضه فالبهيمة خير منه، ولذلك قال الله في ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: 179][6].
ومن معاني الغفلة أن يغفل الإنسان عن المعاني الخفية والباطنة للعبادة، وأنها تفتح أنوارا من الهدايات والثمرات إذ؛
ü لابد أن يجد العابد في عبادته نيل رضا ربه أولا، ويجد فيها ثانيا انشراح صدره ونشاط جسمه، وأن يرى الناس نورها في وجهه.
ü العابد يزيل بعبادته الأحزان والقلق والهم والكسل.
ü العابد يرجو بعبادته المحبة في السماء والقبول في قلوب الناس.
ü العابد يرجو بعبادته زكاة نفسه والغلبة على حظوظها، وأن يجد الطمأنينة والسكينة وراحة البال.
لكن الخطأ الذي شاع بين الناس أن العبادة هي أداء الشعائر من صيام وصلاة وحج وعمرة وزكاة، علما بأن نصوصا تعددت سياقاتها في القرآن والحديث جاءت تبين أن كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل ظاهرا كان أو باطنا؛ عبادة، فعد الشرع الأكل عبادة والشرب والبيع والشراء والزواج والقيام بشؤون الناس وخدمتهم مع إخلاص النية في ذلك كله عبادة، فاستوعبت العبادة كل تفاصيل الحياة، ما دامت غايتها إرضاء الحق سبحانه، فالأعمال الصالحة في قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحاٗ مِّن ذَكَرٍ اَوُ ا۟نث۪ىٰ وَهُوَ مُومِنٞ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُۥٓ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَۖ﴾ [النحل: 97]، إن لم تكن بصفة تعبدية محضة يمكن أن تكون قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ، قالَ: تَعْدِلُ بيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عليها، أوْ تَرْفَعُ له عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، قالَ: والْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ[7]“.
ولما جعلت الشريعة حتى الأعمال العزيزة عبادة حين تصلح السرائر وتوجه النيات، وفي هذا روي أنَّ ناساً قالوا: يَا رسُولَ اللَّهِ، ذَهَب أهْلُ الدُّثُور بالأجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بَفُضُولِ أمْوَالهِمْ قال: أوَ لَيْس قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟! إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدقَةً، وكُلِّ تَكبِيرةٍ صَدَقَةً، وكلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً، وكلِّ تِهْلِيلَةٍ صَدقَةً، وأمرٌ بالمعْرُوفِ صدقةٌ، ونَهْىٌ عنِ المُنْكر صدقةٌ وفي بُضْعِ أحدِكُمْ صدقةٌ قالوا: يَا رسولَ اللَّهِ أيَأتِي أحدُنَا شَهْوَتَه، ويكُونُ لَه فِيهَا أجْر؟ قَالَ: أرأيْتُمْ لَوْ وضَعهَا في حرامٍ أَكَانَ عليهِ وِزْرٌ؟ فكذلكَ إِذَا وضَعهَا في الحلاَلِ كانَ لَهُ أجْرٌ[8]“، لكن شرط لها الشارع الحكيم إلى جانب النية شرط الإتقان وهو رديف الإحسان، وغالبا ما يأتي في سياقاته، وهو مستمد من الحق سبحانه إذ يقول: ﴿صُنْعَ اَ۬للَّهِ اِ۬لذِےٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَےْءٍۖ﴾ [القصص: 90]، وهو في العبادات أكمل الدين وأحسنه، قال الحق سبحانه: ﴿وَمَنَ اَحْسَنُ دِيناٗ مِّمَّنَ اَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٞ﴾ [النساء: 124].
والمحسن المتقن في العبادة هو الذي يبني مجتمع الخير، فإذا كانت العبادة وفق “أن تعبد الله كأنك تراه” وحضر فيها الظاهر والباطن، واستوى فيها الإسرار والجهر ورؤية الناس وعدمها تحققت ثمراتها.
إن العبادة إذا كانت على هذه الصفة أنتجت عابدا يؤدي واجبه ويأخذ حقه، وتنفعه عباداته فتبرز آثارها في محيطه المهني والاجتماعي والأسري، فيجد العابد المحسن طريقه في الكون صلاحا يصلح به البلاد، وتبقى فضيلة الإحسان معلقة برقاب العابدين قبل غيرهم.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر 1984، 5/220.
[2] صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث 2577.
[3] جامع العلوم والحكم، ابن رجب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة، الطبعة الثانية 2004، 2/679.
[4] صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث 6502.
[5] إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة-بيروت، 1/330.
[6] الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، تحقيق أبو اليزيد أبو زيد العجمي، دار السلام-القاهرة 2007، ص: 83.
[7] أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه (4/ 56)، رقم: (2989)، ومسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (2/ 699)، رقم: (1009).
[8] صحيح مسلم: 1006.